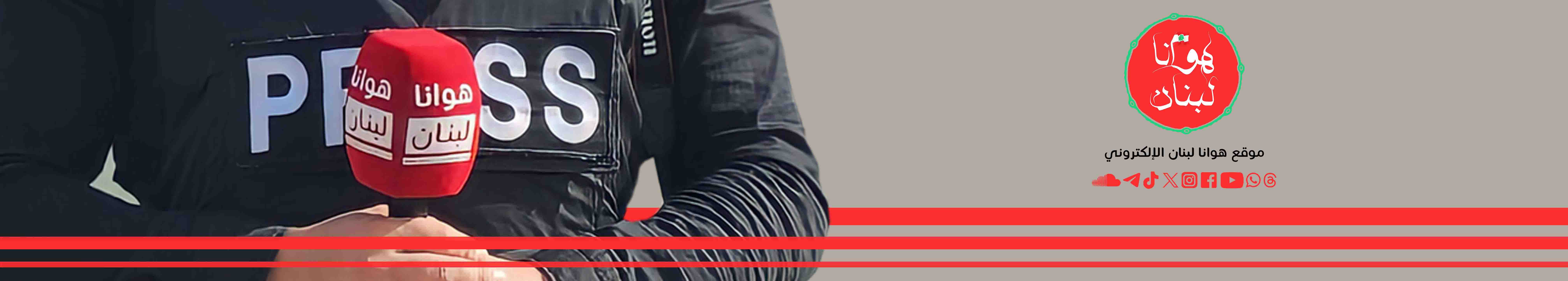الانضباط أساس البناء الأخلاقي .. كيف نعين أبناءنا على ضبط شهواتهم
السيد عباس نورالدين
إن كنّا نريد أن نشرع في تربية أبنائنا تربيةً أخلاقيةً معنويةً تكامليةً، فلا يوجد نقطة بدء وانطلاق أهم وأولى من العمل على ترسيخ ملكة الانضباط وقوّة السيطرة على النفس.
والمقصود من “ضبط النفس” هو إخضاع جميع قواها لسلطان إرادة واحدة تكون واعية تمامًا لما يصدر منها ويجري عليها(وهذا ما يندرج تحت عنوان إدراك نتائج الأفعال الاختيارية). ففي البداية تكون نفس الوليد الذي انفصل لتوّه عن رحم أمّه تابعةً لنفس الأم تبعية شبه تامّة؛ فهو لا يعلم من هذا العالم سوى هذا المصدر الوحيد الذي يغذّيه ويؤمّن حاجاته. وشيئًا فشيئًا تبدأ نفس الطفل بالانفصال عن نفس الأم، ويحصل له شعور باستقلالها وهويّتها بواسطة إدراك فاعليتها ودورها في تحريك أعضاء بدنه المستقل عن بدن أمه. إلا أنّ ذلك الاستقلال والوعي الذاتي لا يحصل دفعةً واحدة، لأنّ تجربة النفس في تحريك الأعضاء تكون متدرّجة، وتحصل على مدى الأشهر والسنين، وتخضع لعوامل بيئية وتربوية متفاوتة.
تكون نفوس البشر في أوّل الأمر بمنتهى الضعف والعجز، وتدبيرها لأبدانها يكون ساحة تمرينها وتقويتها. وكلّما اكتشف الطفل العلاقة بين نفسه وأعضائه وأعمل إرادتها فيه، ازداد اتّصاله ببدنه وتحقّق الانفصال التام عن بدن أمّه وإرادتها؛ فتزداد النفس بذلك قوّةً وإرادة. ولكن، بما أنّ لكلّ عضو من أعضاء البدن دورًا خاصًّا يختلف عن الآخر، فقد يحدث أن تتشتّت النفس بسبب اختلاف أدوار الأعضاء واتّجاه كلّ واحدٍ منها إلى حاجة خاصّة. ولأنّ العضو الأهم والأولى لهذا البدن بالنسبة للطفل الصغير هو المعدة (الحاجة إلى الغذاء تفوق كل شيء هنا)، فإن تعلّق نفسه وتبعيتها لهذا العضو ستكون شبه مطلقة. فإن جاعت علا صراخه واشتدّ وجعه، وكأنّ العالم كلّه ينهار من حوله وتظلم الدنيا في عينيه ويفقد أي أمل بالبقاء؛ وإن شبعت بطنه، استقرّت نفسه واطمأنّت وكأنّه فرغ من كل غم وهم.
ولأنّ الحواس تكون في البداية في موقع المنفعل، فإنّ المسموعات والمبصَرات والمشمومات والمذوقات التي ترد على نفس الطفل من الخارج، ومن دون إرادة منه أو اختيار، ستكون هي الفاعل المؤثّر في النفس، تصبغها بصبغتها وتنعتها بنعوتها، وذلك نظرًا لخلوّ النفس تقريبًا من أي محفوظات أو مخزونات حسية يمكن مقارنتها بها؛ ونظرًا لضعف القوّة العاقلة في هذه المرحلة العمرية المبكرة وعجزها عن فهم وتحليل وإدراك مدلولاتها. لهذا، سوف يكون للانفعالات النفسية الحاصلة من تماس الحواس مع العالم الخارجيّ دورٌ حسّاس جدًّا على المدى البعيد، نظرًا لما تتركه في أعماق النفس من نقوشات يصعب زوالها (العلم في الصغر كالنقش في الحجر). وما لم يتم ضبط هذه الحواس على مدى الأيام، فمن المتوقّع بعد ذلك أن تصبح مطالبها من المسموعات والمبصرات وأمثالها حاكمة على النفس تميل بها حيث تشاء، حتى لو كانت من سنخ اللغو والعبث والبشاعات والمكدِّرات.
أمّا القوّة الثانية من حيث التأثير على النفس بعد المعدة فهي جارحة اللسان، التي يمكن أن تجرّ النفس نحو أشكال الأفعال العابثة والمخلّة، فيما إذا استُعملت بطريقةٍ عشوائية. وقد يرث الأطفال، نتيجة إصرار الأهل على نطق الأبناء بأي طريقة كانت وبأسرع وقت ممكن، هذه العشوائية الكلامية واللغوية ويرثون معها تشتّت النفس، التي استأنست أشدّ الأنس بفعالية اللسان. فما أكبر ما يجلبه هذا اللسان للطفل إن هو نطق ببعض الكلمات التي لا يُفهم معانيها، ففي بعض الحالات سينال من جدّه هدية نفيسة، وأهم منها ذلك الحب الشديد.
لأجل ذلك سوف تكون هذه العشوائية اللسانية والتفلّت وعدم انضباط هذه الجارحة أحد أكبر المهام التي ستُلقى على عاتق هذا الطفل فيما بعد، إن هو أراد الشروع بضبط نفسه والإمساك بزمامها.
ومع المشارفة على سن البلوغ وانبعاث القوّة الجنسية، يمكن أن تؤدّي الأجواء المتفلّتة داخل البيئة المتساهلة إلى انطلاق هذه القوّة واسترسالها دون هوادة وهداية، فتجر معها النفس إلى الكثير من الرغبات العجيبة. وهذا ما يحصل للأسف في المجتمعات والبيئات الغربية، سواء كانت في أمريكا أو في بيروت. وسوف نخصّص فصلًا مستقلًّا للحديث عن التربية الجنسية إن شاء الله.
إنّ تشتّت النفس وتفلّتها يحصل جرّاء تبعيتها للأعضاء والجوارح التي يلحق كل منها حاجاته ويتبع ميوله، بمعزل عن المصلحة والفائدة والنفع. فمن تبع معدته تأخذه إلى تخيّر أنواع المأكولات والمشروبات، غير عابئ إذا ما كان ذلك سيؤدّي إلى ضرره ومرضه. ومن تبع فرجه أخذه إلى أنواع العلاقات والمقاربات من دون أن يكترث لما يمكن أن يجلبه له ذلك من أنواع المشاكل والمصائب، وهكذا…
إنّ المشكلة الأولى التي تنجم عن هذا التفلّت هي التي ترتبط بالأضرار التي تلحق بالبدن على المدى القريب أو البعيد، كأنواع الأمراض والأزمات الصحية والضعف والعجز والإعاقة وقصر العمر. والنوع الثاني من المشاكل، وهو الأشد وخامة، يرتبط بمقام النفس وأحوالها ومصيرها؛ فإنّ من تبع شهوات بدنه أنزل نفسه في مقام البهيمية وجعل شهواته محل استعار نيران قوّة غضبه، التي سرعان ما تودي به إلى درك الشيطنة والمصير المشؤوم.
لذلك، يحتاج كل إنسان إلى أمرين أساسيين:
الأول، إخضاع جميع قوى نفسه لسلطانٍ واحد حتى يخرج من هذا التشتّت.
والثاني،أن يكون هذا السلطان هو الله تعالى، لأنّه عزّ وجل العالم بمصالح النفس، ولأنّه خير قائد وهاد.
يقول الإمام الخميني قدّس سرّه:”إنّ من أسرار العبادات والرّياضات ونتائجهما أنْ تصبح إرادةُ النّفس في مُلْكِ البدن نافذةً، وتصير مملكةُ النّفس منقهرةً ومضمحلّةً في كبريائها، وتسيطر الإرادة على القوى المبثوثة والجنود المنتشرة في مُلْكِ البدن وتمنعها من العصيان والتمرّد والأنانيّة، وتكون القوى مسلمة لِمَلَكوت القلب وباطنه، بل تصير جميع القوى بالتدريج فانيةً في المَلَكوت، ويطبّق أمرُ المَلَكوت في المُلْكِ وينفّذ فيه، وتقوى إرادةُ النّفس، ويفلُت زمامُ المَمْلكة من يد الشّيطان والنفس الأمارة، وتُساق جنودُ النّفس من الإيمان إلى التّسليم ومن التّسليم إلى الرّضا ومن الرّضا إلى الفَناء”.[معراج السالكين، ص38]
أمّا الأمر الأول فيتحقق عبر الرياضة والتمرين. وأمّا الثاني فيحصل من خلال تحكيم سلطان العقل الذي هو مظهر حكمة الله تعالى في أرض الطبيعة. وكلا الأمرين ممكن في ظلّ التربية الأخلاقية السليمة.
إنّ أكبر معين على رياضة ضبط النفس (ترويض النفس) يمكن أن يكون في المرحلة العمرية الأولى عبارة عن ذلك المقابل أو الجائزة التي يحصل عليها الطفل إن هو ضبط نفسه فامتنع عن الإكثار من الطعام أو الثرثرة مثلًا، وهي العاطفة والمودة والرحمة والعناية والاهتمام المعنويّ الذي يمكن أن يحصل عليه ممّن حوله، وخصوصًا من كان لهم الدور الأكبر في حياته ـ والتي تضاهي عنده بل تفوق لذائذ الحواس والبطن.
حين نحيط أبناءنا بعاطفة جيّاشة وننشئهم على الرحمة والمودّة فتنعجن نفوسهم بالحب والحنان، نكون قد أدخلنا إلى حياتهم لذّة وبهجة ومتعة معنوية كبيرة، يصبح الحصول عليها مطلوبًا أكثر من أي شيء آخر، وتصبح خسارتها أو فقدانها أصعب من أي خسارة أخرى. ولهذا، غالبًا ما يؤدّي الحرمان العاطفيّ عند الأطفال إلى مشكلات سلوكية من النوع الذي يظهر بصورة المشاغبة الشديدة والنهم والحرص على الماديات.
أمّا في المرحلة الثانية، فمن المفترض أن يدخل عنصرٌ آخر إلى ساحة المعركة، وهو العقل الذي يبدأ عندها بالتفتح في قلب الطفل، لتبدأ معه مهمّة المربّين بالحض على استعماله بواسطة إراءة نتائجه وآثاره وتعظيم دوره وبيان كيفيّة استعماله. وهذا ما يرجعنا إلى فصول التربية العقلية.
وفي البداية يكون نصيب الطفل من العقل ما يدرك به نتائج التجارب وآثارها. فإمّا أن يمرض الطفل وتنتكس حالته الصحية بسبب إفراطه في الطعام أو تناول ما لا يصح حتى يلتفت إلى العلاقة السببية بين هذا وذاك، وإمّا أن يشاهد هذه الحالة في غيره أو يقرأ عنها ويسمع بطريقة باعثة على تصديقه.
وما لم تبلغ قوّة التعقّل في الإنسان مقامها الأرفع، لن يكون قادرًا على استشراف النتائج دون ملاحظة التكرار في التجارب. ولهذا، قد يقع في أزمات ومشكلات كثيرة، لأنّه لم يعاينها من قبل، ولم يعرف عنها شيئًا.
يقول الإمام الخميني(قده): “إنّ من أسرار العبادات وفوائدها أن تتقوّى إرادة النفس، وتتغلّب النّفس على الطبيعة، وتكون القوى الطبيعية مسخّرةً تحت قدرة النّفس وسلطنتها، وتكون إرادة النّفس المَلَكوتيّة نافذةً في مُلكِ البدن بحيث تكون القوى بالنّسبة إلى النّفس كملائكة الله بالنسبة إلى الحقّ تعالى {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} .
فنقول الآن: إنّ من أسرار العبادات وفوائدها المهمّة التي تكون بقيّة الفوائد مقدّمة لها، أنْ تصبح مملكة البدن بكلّها، ظاهرها وباطنها، مسخّرةً تحت إرادة الله ومتحركة بتحريك الله تعالى، وتكون القوى المَلَكوتية والمُلْكِيّة للنّفس من جنود الله، وتكون كلّها كملائكة الله. وهذه من المراتب النّازلة لفناء القوى والإرادات في إرادة الحقّ. ويترتّب على هذا بالتّدريج النّتائج العظيمة ويصبح الإنسان الطبيعيّ إلهيًّا؛ وتكون النّفس مرتاضةً بعبادة الله، وتنهزم جنودُ إبليس بشكل نهائيّ وتنقرض، ويكون القلب مع قواه مسلّمًا للحقّ، ويَبرز الإسلام ببعض مراتبه الباطنيّة في القلب، وتكون نتيجةُ هذا التّسليم لإرادة الحقّ في دار الآخرة أنّ الحقّ تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالِم الغيبيّة، ويجعله مثلًا أعلى لنفسه. فكما أنّه تعالى وتقدّس يُوجد كلّ ما أراد بمجرد الإرادة، يجعل إرادة هذا العبد أيضًا كذلك؛ كما روى بعض أهل المعرفة عن النبي صلّى الله عليه وآله في وصف أهل الجنّة أنّه يأتيهم ملكٌ فيستأذن للدخول عليهم وبعد الاستئذان يدخل فيبلّغ السّلام من الله تعالى عليهم ويعطي كلًّا منهم رسالةً مكتوبًا فيها:
من الحَيِّ القَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوْتُ إِلَىْ الحَيِّ القَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوْتُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْن وَقَدْ جَعَلْتُكَ تَقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْن، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ: فَلَا يَقُولُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ لِلشَّيْءِ كُنْ إِلّا وَيَكُوْن”. [معراج السالكين، ص 45-46]