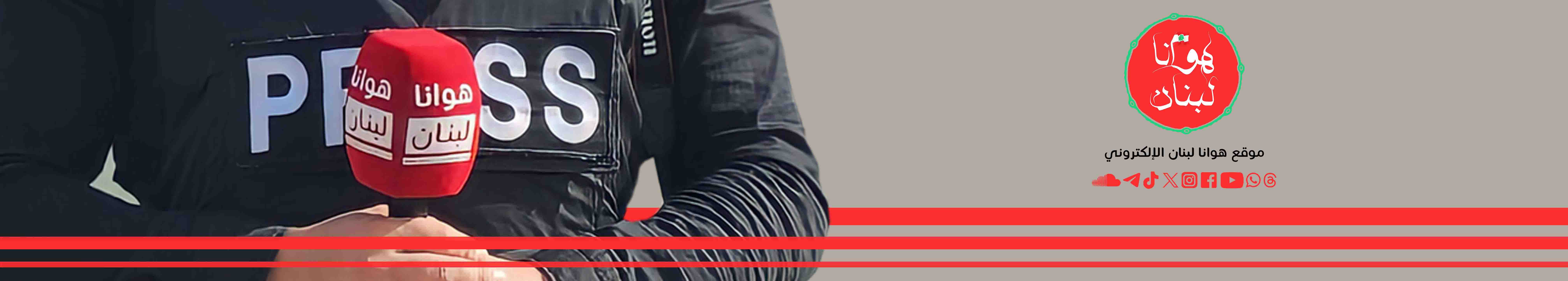الدكتور بلال اللقيس | عندما تدخل المنطقة والعالم عتبة جديدة
الدكتور بلال اللقيس
تُفيد نظريات السياسة بأنّ تأثير القوى «الوسطى» في لحظات التحوّل الدولية يزداد، وأنّ الأحلاف الجامدة تتراجع لصالح تلك المرنة أو المرتبطة بـ«الموضوعة»، وأنّ القوى المهدّدة بالتراجع والقلقة على مستقبلها يزداد خطرها وانفعالها. نوضح بالقول إنّ القوى الوسطى (تعريف العظمى والكبرى والوسطى يرتبط وفق النظام الدولي الحالي بشكل أساسي بالقوة المادية) تتحرّك لتعزيز موقعها ومكانتها لحاجة القوى الكبرى المتصارعة إليها. كل من المتصارعين يخشى أن تغادره إلى الضفّة المقابلة، ما يضطره في الغالب على مسايرتها ومواكبتها بدل مجابهتها ومنعها إدراكاً منه للأكلاف المحتملة. وقد يقدّم إغراءات وبدائل لها كثمن لموقفها. عملياً، تستفيد القوى الوسطى من التناقضات وتعزّز مكانتها وقد تنتقل إلى الملعب الأوسع إذا ما امتلكت مقوّمات ذاتية كافية وبراعة سياسية للتعاطي مع المرحلة وفرصها.
تزداد أهمية القوى المتوسطة كلّما كان موقعها الجيوبوليتيكي يشكّل بوابة أو معبراً جيوستراتيجياً. هذا هو حال بعض القوى الإقليمية اليوم وفي مقدّمتها إيران التي تتميّز، فضلاً عن كونها قوّة متوسطة (رغم أنّه في توصيف قوتها نقاش كونها أقدر عملياً من بعض دول الفيتو)، أنّها ساحة ربط بين الجيوبوليتيكي والجيوستراتيجي وأنّها قادرة أن تلعب دور بيضة قبان في اللعبة الدولية وتنافساتها وصراعاتها. فضلاً عن ذلك كلّه، فإنّ إيران تمتلك ميزة «نسبية» و«تنافسية» في آن تتجاوز فيها مثيلاتها من القوى المتوسطة في العالم بأسره. فهي في الحقيقة قوّة تعديلية وتغييرية في النظام الدولي. هي قوّة تتميّز بـ«خطاب» في زمن تراجع خطاب الليبرالية الغربية والرأسمالية وزخمه. تمتلك رؤية ومشروعاً يجريان على قدم وساق منذ 4 عقود وأكثر تتقدّم من خلالهما لتعديل، وليس فقط لتعزيز، مكانتها في النظام القائم، وهذا ما أسّست له بقوّة منذ انتصار ثورتها، وتحمّلت أعباء جمّة لإنجازه، وتستعد اليوم لزمن القطاف.
بنت إيران ميزتها ومكانتها على أساس خطاب يتمركز على نظرية المقاومة والتحرّر ورفض الهيمنة والاعتماد على الذات، ولقد تمكّن هذا الخطاب، رغم التحدّيات، من تثبيت أركانه وقواعده في كل المجتمعات بأصالة، لا تبعية، فانبجست منه نماذج ذاتية الخصائص والرؤية والتشخيص تحت مظلّة نظرية المقاومة والتحّرر. رأت الجمهورية الإسلامية العالم كرقعة شطرنج بطبقات متعدّدة، لا طبقة واحدة، وهذه الرؤية المتميّزة أعطتها ثقلاً خاصاً وهوية في زمن تضعضع الهويات، ربّما رأته أحادي القطبية عسكرياً وثنائياً اقتصادياً، ولكن بالتأكيد هو متعدّد الأقطاب ثقافياً واستراتيجياً، فبنت مركّب قوّتها لا على أساس المنافسة العسكرية بل الدفاع الفعال عن السيادة والمكتسبات. ولا على أساس مواجهة اللحظة بل المستقبل. ولا على أساس الدفاع النسبي فقط إنّما على الأمن القومي الواسع والمرن والمُستبق. ولا على أساس المنافسة الاقتصادية بالمنظور الرأسمالي الليبرالي إنّما على أساس يمكنها من تأكيد هويتها واستقلالها أولاً وشقّ طريق المساعدة والدعم للبيئة الإسلامية والمتضررين من الهيمنة والتكامل معهم. ولا على أساسس التبعية الثقافية إنّما الافتخار بالهوية الدينية – الوطنية.
إنّ الحضور العالمي المقبل وحجز المكانة فيه يحتاجان إلى رؤية تحوي تكاملات إقليمية سياسية وأمنية واقتصادية تصبّ في صالح الجميع وتطمئنهم، لا نزاعات تحرم الجميع من التقاط الفرصة.
بينما تدخل إيران هذا الأفق الجديد لتسييله، تقف «إسرائيل»، ذراع الهيمنة الغربية الأبرز في المنطقة وعدو إيران الوجودي، عند حقيقة التراجع الحاد في تأثيرها، وتواجه وحيدة مسار عزلة يطوقها، ويزداد شعورها بعدم اليقين في مستقبلها، ناهيك عن صورتها في أعين الغرب أنّها لم تعد حصاناً رابحاً بل أضحت حصاناً مكلفاً وثقيلاً ومريضاً تفتك به الأمراض الداخلية ويعجز عن الانطلاق في البيئة الخارجية بعدما تراجعت الحاجة إليه وصار عبئاً. صار بحاجة أن يُحمى عوضاً عن أن يحمي (شريطة أن لا تمدّ له السعودية حبل نجاة التطبيع وتعود وتقحم نفسها في أتون أزمات المنطقة وصراعها الكبير).
يمر عالمنا اليوم بلحظة تحول تاريخي يستبطن جملة متغيرات عميقة وبعيدة المدى مختلفة إلى حد كبير عن نظام تعدد الأقطاب الذي عرفه القرن التاسع عشر، والقطبين في النصف الثاني من القرن العشرين، والقطب الواحد حتى العقد الأوّل من الألفية الثالثة، هي شيء جديد بكل الأبعاد والمدارات. نستطيع الادعاء بأنّ الصيغة التي تتولّد وتشقّ طريقها، من «شانغهاي» إلى «البريكس» إلى حرب شرق أوروبا إلى انتقال القوة نحو الشرق، تنبئ بإخفاق الرأسمالية و«موت الإنسان» و«موت الكاتب». كلّها تشير إلى ولادة قيصرية لا تُشبه ما قرأناه أو عرفته البشرية من أشكال نظام دولي، ولا أظنّ أنّ شكل النظام المقبل سيكون ثنائياً أو متعدّد الأقطاب كما يردّد بعضهم، القضية أعقد وأخطر.
أمّا الإقليم، فتتولد فيه ديناميات جديدة نتجت عن توازن قوى جديد بدأت مع انطلاق قطار التفاهمات وعودة العلاقات الإيرانية السعودية. ديناميات تحركها لغة المصلحة والعقل بحسب التتبع والمراقبة، ما يشي أنّ مسار الانفتاح وتوسيع العلاقات الإسلامية الإسلامية والعربية الإسلامية سيدخل أطواراً جديدة. إنّ هذا المستجدّ الكبير والاستثنائي يفرض على إيران، كمفعّل ومحرّك استراتيجي في الإقليم، أن لا تتوقّف عن عملية بناء الثقة والانفتاح على كل القوى الإقليمية العربية – الإسلامية وتزخيم التعاون، فأي مكانة للمنطقة لا تُستطاع إلا بتعاون قواها بعد أن أدركت حدود الممكن وحدود الاعتماد على الخارج وكلفة الهروب من الحقائق وخطر مجافاة العلمية والتواضع في النظر إلى الأمور، وبعد أن أدرك شركاء الغرب «القديمون» انتهاء صلاحية نظرية «التوازن» التي أنهكت فيها أميركا المنطقة لعقود خلت واستغلّتها.
على ضوء ما ذُكر وغيره الكثير، فإنّ الحسابات الأميركية حيال منطقة غرب آسيا تبدو أكثر تعقيداً وصعوبة في ظل صراع عالمي متعدّد الدوافع والأوجه والطبقات. مستنقع المنطقة خطر تتجنّبه وشبح يقلق المجتمع الأميركي، وفي الوقت نفسه تبقى المنطقة استثنائية في مزاياها وحيويتها لأي قوّة هيمنة وحاجة، والتوازن بين الأمرين يزداد صعوبة مع انزياح ميزان القوة في المنطقة لصالح محور المقاومة، ومع تطلّع خصوم دوليين إليها لأدوار وحضور في المنطقة مستفيدين ممّا تربطها من علاقة متوازنة بين إيران والعرب، بينما هي في حالة خصام مع القوة الإقليمية الأهم -إيران- وليست على ما يرام مع شركائها التقليديين وفائض عداء شعبي لها.
على ضوء هذه المتغيرات الكبرى في إقليمنا والعالم، فإنّ أميركا لم يعد بإمكانها تفعيل أو استخدام لغة الحروب والتغيير بالقوة للخرائط بعدما فشلت في ذلك في ذروة قوتها، ولم تعد قادرة أن تمارس تصوّر «القيادة من الخلف» لأنّها فقدت القدرة على تشكيل سياسات حلفائها وشركائها وتوجيه قرارهم قبل خصومها، ولم يعد بمقدورها أن تمارس هيمنتها من خلال مؤسسات دولية متهالكة وتعاني من فراغ معنى (أمم متّحدة ومجلس أمن وغيرهما من المؤسسات والوكالات التي فقدت ميزتها) ولم تعد قادرة أن تمارس سياستها على أساس نظرية الوكلاء التي اعتمدتها لعقود (إيران الشاه، مصر كامب ديفيد، السعودية فهد، تركيا أتاتورك وإسرائيل) حيث كانت تحقّق مصالحها من خلالهم. إنّ مختلف هذه الاستراتيجيات لم تعد صالحة. غالبية الدول العربية تعبر نحو تغيّرات فعلية في علاقتها مع الولايات المتّحدة. أميركا لم يتبقّ لها اليوم فعلياً إلا «إسرائيل»، لكنّ الأخيرة قلقة خائفة وحائرة، وهذا قد يجعل صلاحية إسرائيل تقترب من نهايتها إذا استمر الأمر على ما هو عليه، فتصبح عبئاً على سياسة أميركا في المنطقة ومفاضلاتها بين أكثرية عربية إسلامية تتقارب في إطار بحثها عن مصالحها وصهيونية مهدّدة ومهدِّدة لمصالح الغرب.
إنّ هذه التغيّرات الكبيرة وغير المسبوقة والجديدة تحتّم على الأميركي تعديل مقاربته للحدّ من خسائره وتهاوي نفوذه. يرجّح أن ينتقل من المقاربات الكلية إلى الجزئية، أي بعيداً عن «الباكيج» والسلّة الشاملة، ويتّجه للعمل مع كل ساحة وحالة على حدة – بمعزل إن كانت ساحة شركاء أو ساحة خصوم وأعداء.
إنّ هذا التصوّر سيفتح لنقاش آخر؛ هل ستبقى مصلحته بعد ما يصيبه من تراجعات في إظهار الصراع الإيديولوجي أم بالتوجّه نحو البراغماتية الصرفة حتى مع أعدى أعدائه – إيران – ويتحوّل إلى معيق حيث أمكن وإلى منافس نشط يعوّض للمنطقة حاجاتها ويُظهر أنّه ما زال حاجة ضرورية لأهلها مقابل حراك إيران وروسيا والصين؟ ومع القناعة التي تقول إنّه لن يكون قادراً عملياً على تعطيل مسارات السياسة إن استمرّت القوى الإسلامية والعربية بالبحث عن مصالحها وتقارباتها في الإقليم، وهو ما أعتقد به، لذلك قد ينخرط في مسار ظاهره تنافسي وباطنه صراعي. أميركا، رغم حقدها على أعدائها ورغبتها الجامحة باستئصالهم واجتثاث وجودهم، لكنّها في نهاية المطاف براغماتية وتعرف حدود قوّتها وقدرتها في منطقة تفلت من يدها بسرعة.
لذلك، ستسعى أميركا للحفاظ على مكاسب، أو بكلمة أدقّ تخفيف خسائرها. هي لن تسلّم لأعدائها، هذه المرّة تحضّر لنموذج التضليل السياسي مع كل ساحة على حدة، عبرها أو عبر دور أوروبي أنشط، لملء ما أمكن من فراغات والانخراط للمشاركة بدل التعطيل الذي لم يعد مفيداً لها ويواجه صعوبة في تسييله. فالمجتمعات تحتاج اليوم إلى ملاقاة وأجوبة لا إلى تعطيل وإجهاد إضافييْن، ويرجّح أن تنافس لتلبية حاجات المجتمعات ليس في دعوى تأمين الحمايات بعدما فشلت إنّما في المجالات الأخرى خشية توسع التسلل الصيني وازدياد نفوذ محور المقاومة وتقدّم عقلية البحث عن «المصلحة» عند شركائها في الإقليم. الأميركي دخل مرحلة رؤية المنطقة بأوسع من النظارة الإسرائيلية التي رآها فيها كيسنجر ذات يوم.
اقترب من استحقاق حسم موقفه بين مصالح «إسرائيل» ومصالحه العالمية من بوابة المنطقة وعليه أن يختار. يُرجّح أنّه بدأ رسم سياسته المقبلة للمنطقة على قاعدة «ما بعد إسرائيل».
يبقى أنّ الوجود الأميركي في سوريا هو المسألة الأخطر أمام المنطقة ولا يجب أن يتحوّل بشكل إلى وجود دائم يؤسس لمشكلة استراتيجية مستقبلية للمنطقة، والتعاطي معه بمثابة أولوية. وقبل ذلك، وبعده، التحضرّ والتحوط من عدوان إسرائيلي ستفرضه حالة الكيان الصهيوني الكئيب القلق الذي يهزّ أركانَه سؤالُ المستقبل والوجود، فالتاريخ يفيدنا بأنّه خلال التحولات الكبرى ينشأ الخوف واللايقين عند البعض وتتراكم هواجس المتراجع الذي هو اليوم «إسرائيل»، ما يجعل تصرفها محكوماً باللاعقل واللاوعي أكثر منها بالعقل والوعي والمنطق.